مُحدَّث في 13 مارس 2025
المقدمة: السودان وسط العاصفة
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أدى إلى دخول البلاد في دوامة من العنف وعدم الاستقرار. هذه الحرب لم تكن مفاجئة، بل جاءت كنتيجة لصراعات طويلة على السلطة بين المؤسسة العسكرية والقوى شبه العسكرية، وامتدادًا لانقسامات أعمق داخل النظام السياسي السوداني، الذي لم يتمكن من بناء دولة مدنية مستقرة منذ الاستقلال ولا سيما عقب الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019.
ورغم أن الصراع يبدو داخليًا في ظاهره، إلا أن التدخلات الخارجية جعلته أكثر تعقيدًا، حيث أصبح السودان ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية. من بين القوى الفاعلة في هذا النزاع، الإمارات العربية المتحدة التي تحولت من داعم سياسي واقتصادي إلى لاعب مؤثر في مسار الحرب.
إن الدور الإماراتي في السودان لا يمكن عزله عن استراتيجيتها الأوسع في القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وشمال إفريقيا. فمن خلال شبكاتها الاقتصادية والسياسية، استطاعت أبوظبي أن ترسخ نفوذها في المنطقة، مستخدمة أدوات مختلفة تتراوح بين الاستثمارات في البنية التحتية والزراعة، والتدخلات العسكرية غير المباشرة عبر دعم الفصائل المسلحة التي تخدم مصالحها.
في هذا السياق، تسعى هذه المقالة إلى تحليل دور الإمارات في الحرب السودانية، من خلال استعراض المصالح الاقتصادية، والدوافع الجيوسياسية، والوسائل التي استخدمتها لتعزيز نفوذها في السودان، وكذلك ردود الفعل الدولية والإقليمية تجاه هذا التدخل.
الخلفية السياسية والتاريخية للصراع في السودان
لفهم الحرب الحالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لا بد من العودة إلى الجذور السياسية والتاريخية للصراع، التي تعود إلى عقود من الصراعات الداخلية، والتوترات العرقية، والتنافس بين القوى العسكرية والمدنية. بالإضافة إلى فشل القوى السياسية السودانية في وضع تصور حقيقي لإدارة الدولة. ولكن العامل الأكثر أهمية في تشكيل المشهد الحالي هو الدور الذي لعبته قوات الدعم السريع في النظام السوداني، وكيف انتقلت من أداة قمعية إلى قوة تهدد الدولة نفسها.
البداية: كيف وُلدت قوات الدعم السريع؟
تعود جذور قوات الدعم السريع إلى الميليشيات القبلية المسلحة التي استخدمها نظام الجبهة الإسلامية السوداني (المؤتمر الوطني) خلال حرب دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حينها، كان الرئيس عمر البشير يواجه تمردًا مسلحًا من الحركات الدارفورية المطالبة بحقوق سياسية وتنموية أوسع، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. لكن بدلاً من الاعتماد على الجيش السوداني وحده لقمع التمرد، لجأت الحكومة إلى تسليح ميليشيات محلية ذات طابع قبلي، عُرفت لاحقًا باسم الجنجويد.
تشكّلت هذه الميليشيات أساسًا من عناصر عربية في دارفور، كانت لها نزاعات تاريخية مع المجموعات الإفريقية غير العربية في الإقليم. ومنحها النظام السوداني السلاح والتمويل والصلاحيات المطلقة، مقابل القيام بالعمليات القتالية ضد المتمردين دون أن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات.

من الجنجويد إلى الدعم السريع: التحول إلى قوة شبه رسمية
مع تزايد نفوذ قوات الجنجويد وتحقيقها نجاحات عسكرية في دارفور، أدرك النظام السوداني بقيادة البشير أن هذه القوة يمكن أن تكون أداة عسكرية وسياسية دائمة، وليس مجرد ميليشيا مؤقتة. وفي عام 2013، تم إعادة هيكلة الجنجويد رسميًا تحت مسمى "قوات الدعم السريع"، وجرى تقنين وضعها داخل المنظومة الأمنية السودانية، ولكن دون أن تخضع بشكل مباشر لقيادة الجيش السوداني.
عُيّن محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائدًا لهذه القوات، وهو رجل أعمال (تاجر) من أصول بدوية من قبيلة الرزيقات، صعد بسرعة داخل منظومة السلطة، مستفيدًا من علاقاته القوية بالبشير وعائلته. لعب حميدتي دورًا أساسيًا في تأمين السلطة للبشير عبر استخدام قواته في قمع التظاهرات، وتأمين المناطق الغنية بالموارد، وتنفيذ العمليات الخاصة التي لم يكن الجيش يرغب في التورط بها مباشرة. ومع مرور السنوات، توسعت قوات الدعم السريع لتصبح أكثر من مجرد وحدة قتالية، حيث دخلت مجال التجارة، وتهريب الذهب، والأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما منحها استقلالية مالية غير مسبوقة عن الدولة السودانية، وهو ما مهّد لاحقًا لمواجهتها مع الجيش.
الدور المتنامي للدعم السريع في حكم البشير
في سنوات حكمه الأخيرة، اعتمد البشير على قوات الدعم السريع كـأداة موازنة للجيش السوداني، الذي بدأ بعض قادته في التململ من سياساته. لم يكن البشير يثق في الجيش بالكامل، خاصة مع سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدها السودان على مدار تاريخه. لذلك، منح قوات الدعم السريع صلاحيات واسعة لحماية النظام، وتأمين الخرطوم، وتنفيذ العمليات القذرة التي لا يريد أن يتحمل الجيش مسؤوليتها مباشرة. ولكن البشير لم يدرك أنه كان يبني وحشًا خارج نطاق السيطرة. فبينما كان يعتمد على قوات الدعم السريع، كانت هذه القوات تنمو اقتصاديًا وعسكريًا، وتبني تحالفات مع جهات خارجية، وتؤسس لنفسها هوية مستقلة عن الدولة السودانية.

وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في السودان بين 2013-2018، لعبت قوات الدعم السريع دورًا مركزيًا في قمع المظاهرات، حيث تورطت في قتل المتظاهرين في عدة مجازر. لكن أثناء سقوط نظام المؤتمر الوطني (الجبهة الإسلامية)، بدأ حميدتي في لعب لعبة مزدوجة، حيث قدّم نفسه كـحامٍ للثورة وشريك في التغيير السياسي، مما سمح له بالبقاء في السلطة بعد سقوط البشير.
ما بعد البشير: الدعم السريع لاعب رئيسي في المشهد السياسي
بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، كان واضحًا أن قوات الدعم السريع لم تعد مجرد ميليشيا تابعة للرئيس المعزول، بل أصبحت قوة قائمة بذاتها. دخل حميدتي في شراكة غير مستقرة مع عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، ضمن المجلس السيادي الذي حكم السودان خلال الفترة الانتقالية. لكن هذه الشراكة كانت مبنية على المصالح المؤقتة، وليس على رؤية موحدة لمستقبل السودان. بينما كان الجيش يسعى إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية، كان حميدتي يرفض ذلك تمامًا، حيث أدرك أن دمج قواته في الجيش يعني خسارته لنفوذه المالي والعسكري والسياسي. هذا الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني كان الشرارة الرئيسية التي فجرت الحرب بين الطرفين في أبريل 2023.

من أداة للنظام إلى خطر وجودي على الدولة
اليوم، أصبحت قوات الدعم السريع أكبر تهديد وجودي للدولة السودانية. فبعد أن كانت قوة وظّفها نظام الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني الذي قاده البشير لتعزيز قبضته على السلطة، تحولت إلى جيش موازٍ ينازع الجيش السوداني على الحكم والموارد. ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو أن قوات الدعم السريع ليست مجرد ميليشيا محلية، بل لديها روابط وتحالفات إقليمية ودولية، خصوصًا مع الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت أحد أهم داعميها اقتصاديًا وعسكريًا. وهنا تبدأ قصة الدور الإماراتي في السودان، والذي سنتناوله في محور لاحق.
الدور الإقليمي والدولي في تأجيج النزاع
رغم أن الحرب في السودان نشأت نتيجة خلاف داخلي بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلا أن الصراع لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من التعقيد والدمار لولا التدخلات الخارجية. منذ الأيام الأولى للحرب، ظهر بوضوح أن أطرافًا إقليمية ودولية لديها مصالح متشابكة في السودان، تسعى إما لدعم أحد طرفي النزاع أو استغلال الفوضى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
الدور الإماراتي والروسي وتأثيرهما في دعم قوات الدعم السريع

تلعب الإمارات دورًا رئيسيًا في دعم قوات الدعم السريع في الصراع السوداني، حيث تعتمد استراتيجيتها على تعزيز نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في السودان والمنطقة المحيطة. تقدم الإمارات دعمًا ماليًا ولوجستيًا لقوات الدعم السريع، مدفوعة بمصالح متعددة، من أهمها تأمين طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وضمان استمرار تدفق الذهب السوداني، الذي يعد مصدرًا مهمًا لتمويل هذه القوات. وتعتمد الإمارات في هذه الاستراتيجية على تحالفاتها مع قوات محلية مسلحة ذات نفوذ، بهدف تحقيق مصالحها مع التدخل العسكري المباشر المحدود. ويساهم هذا الدعم في تعزيز قوة قوات الدعم السريع وقدرتها على التوسع والسيطرة على موارد استراتيجية، خاصة في مناطق الذهب والنفط، ما يعقد المشهد السوداني بشكل أكبر.
من جانبها، تلعب روسيا دورًا محوريًا في دعم قوات الدعم السريع، وذلك من خلال مليشيات مسلحة كمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي تُعتبر ذراعًا غير رسمي للنفوذ الروسي في أفريقيا. تسعى روسيا، عبر هذه المجموعة، إلى تحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية، حيث توفر التدريب والمعدات العسكرية لقوات الدعم السريع مقابل تأمين مصالحها في الموارد السودانية، وأهمها الذهب. تعتبر تجارة الذهب في السودان جزءًا من شبكة أوسع تستفيد منها روسيا، خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها نتيجة للحرب على أوكرانيا، مما يجعل الذهب السوداني مصدرًا مهمًا للتمويل وتجاوز القيود المالية. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر طموحات روسيا في بناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، من خلال علاقتها بقوات الدعم السريع، رغبتها في تعزيز وجودها العسكري وتأمين نفوذها في المنطقة. هذا التواجد يخدم روسيا استراتيجيًا، إذ يمكنها من توسيع نطاق عملياتها في البحر الأحمر، وتعزيز موقعها في القرن الأفريقي.
الدور المصري والسعودي في دعم الجيش السوداني

تتبنى مصر والسعودية موقفًا داعمًا للجيش السوداني، ولكن بأساليب ومصالح مختلفة. تُعتبر مصر حليفًا تقليديًا للجيش السوداني، حيث تجمع البلدين علاقات استراتيجية متجذرة تاريخيًا، تقوم على المخاوف المشتركة المتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة قضية مياه النيل. بالنسبة لمصر، فإن دعم الجيش السوداني ضروري للحفاظ على التوازن السياسي والأمني في السودان، ولتجنب تصاعد نفوذ الفصائل المسلحة غير النظامية مثل قوات الدعم السريع، مما قد يؤثر على أمنها المائي وحدودها الجنوبية. وقد ظهر الدعم المصري للجيش السوداني بشكل واضح في تقديم المساعدات العسكرية والسياسية، بهدف تقوية دوره في الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
أما السعودية، فيتسم موقفها تجاه الصراع السوداني بدرجة من الحياد العلني، مع ميل غير مباشر لدعم الجيش السوداني. تُدرك السعودية أهمية استقرار السودان، خاصة فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ولكن، على عكس الموقف المصري الصريح، تميل السعودية إلى ممارسة دبلوماسية هادئة عبر استضافة محادثات السلام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، في محاولة للحفاظ على علاقات متوازنة مع الأطراف المتصارعة. يعكس هذا الدور الوسيط رغبة السعودية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتجنب الانحياز العلني لأي طرف، مع دعم الجيش السوداني بشكل غير مباشر لتحقيق التوازن في مواجهة قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات وروسيا.
في المحصلة، يظهر أن كلا من الإمارات وروسيا يميل إلى دعم قوات الدعم السريع لتحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية في السودان، بينما تعمل مصر والسعودية على دعم الجيش السوداني لأسباب تتعلق بالاستقرار الإقليمي، وتأمين المصالح المشتركة في البحر الأحمر، وتوازن القوى في المنطقة. يؤدي هذا التداخل في المصالح والدعم إلى تعقيد الصراع السوداني، ويجعل الحل السياسي أكثر صعوبة، في ظل وجود قوى دولية وإقليمية تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة عبر دعم الفصائل المسلحة في البلاد.
الدور القطري والإيراني في الصراع السوداني
في سياق الصراع السوداني، تتخذ قطر وإيران أدوارًا أقل تأثيرًا مقارنة بالإمارات، روسيا، مصر، والسعودية، إلا أن لهما اهتماماتهما الخاصة، التي تنبع من مواقف إقليمية واستراتيجية أكبر.
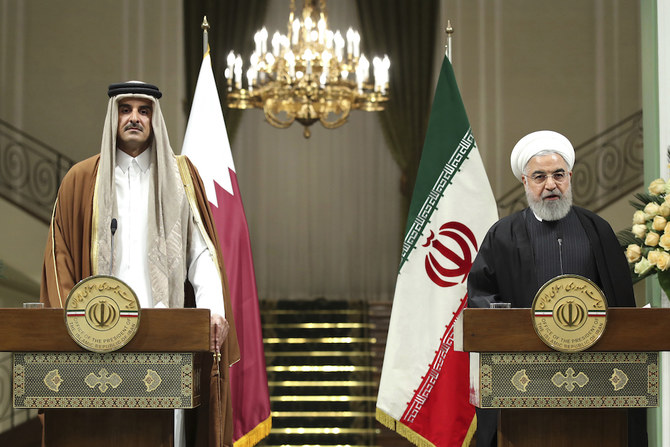
لعبت قطر دورًا مهمًا في السودان خلال العقد الماضي، خاصة عندما كانت تدعم حكومة عمر البشير، ومع سقوط البشير وتشكيل الحكومة الانتقالية في 2019، استمرت قطر في دعمها السياسي والاقتصادي للحكومة الانتقالية. وقد تمثل الدعم القطري في الاستثمار وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى السعي لتعزيز الاستقرار السياسي في السودان، مستغلة علاقتها المتوازنة مع الأحزاب الإسلامية المؤثرة في البلاد.
رغم أن قطر لا تلعب دورًا مباشرًا في دعم الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، فإن اهتمامها الأساسي يتركز على دعم القوى السياسية التي يمكن أن تكون بمثابة توازن مضاد للنفوذ الإماراتي والسعودي، وخصوصًا في أعقاب الأزمة الخليجية 2017. تهدف قطر إلى تقوية الأطراف السودانية التي تتوافق مع رؤيتها الإقليمية، حيث تفضل القوى التي لها صلات بالحركات الإسلامية، وتبتعد عن الأطراف ذات الطابع العسكري غير النظامي. ومع اندلاع الصراع الحالي، تتبنى قطر نهجًا دبلوماسيًا متوازنًا، داعية إلى الحوار والحل السلمي بين الأطراف السودانية، بهدف حماية استقرار البلاد دون التورط في دعم عسكري مباشر لأي من الجانبين.
أما إيران، ففي ظل التنافس الإقليمي وتأثيره على الصراع السوداني، برز دور إيران كداعم للجيش السوداني من خلال تقديم دعم عسكري ملحوظ، خاصة عبر تزويد الجيش بطائرات مسيّرة (درونز) وأسلحة متطورة. فهناك تقارير شبه مؤكدة تشير إلى أن إيران قد قامت بتزويد الجيش السوداني بعدد من الطائرات المسيرة من طراز "محاجر-6" وغيرها، وهو ما مكّن الجيش من تعزيز قدراته في العمليات ضد قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق حول الخرطوم وأم درمان. (Africa Defense Forum) - (Iran International)

تعزز هذا التعاون بشكل أكبر بعد زيارة وفد سوداني إلى إيران في محاولة لاكتساب المعرفة حول تشغيل الطائرات المسيرة الإيرانية والاستفادة منها في العمليات العسكرية. وقد جاء هذا التعاون بعد رفع حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في أكتوبر 2023، مما سمح للسودان بالتوجه لإيران لتعزيز قدراته العسكرية. تعتبر إيران واحدة من أكبر موردي الطائرات المسيرة، والتي استخدمت في صراعات أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا، وكذلك من قبل الحوثيين ضد السعودية والإمارات وإسرائيل خلال حرب غزة.
بالإضافة إلى الدعم العسكري، تمثل العلاقة المتجددة بين إيران والسودان عاملاً استراتيجيًا لإيران، حيث تهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، خاصة على ساحل البحر الأحمر. بينما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية إيرانية في السودان، فإن هذا يبقى احتمالًا قائمًا، خصوصًا مع تطور العلاقات الثنائية التي تسمح لإيران بالاقتراب من الممرات البحرية الهامة، وإلى موقع استراتيجي قريب من منافستها الإقليمية، السعودية. (Africa Defense Forum) - (Modern Diplomacy)
أعادت إيران والسودان علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2023 بعد سنوات من التوتر منذ 2016، مما سمح بفتح قنوات جديدة للتعاون العسكري والاقتصادي، وتوفير إيران لمزيد من الدعم العسكري للجيش السوداني بهدف تعزيز نفوذه وتقوية موقعه أمام قوات الدعم السريع. في الوقت الحالي، لم يؤد هذا الدعم الإيراني إلى تغيير حاسم في مسار الصراع السوداني، ولكنه يُشكل عاملًا مهمًا في تعزيز القوة العسكرية للجيش السوداني وقد يؤثر على موازين القوى في المستقبل. (Modern Diplomacy)
الإمارات: اللاعب الأكثر تأثيرًا في النزاع
رغم تعدد اللاعبين الدوليين والإقليميين في السودان، إلا أن الإمارات تبرز كأحد أكثر الفاعلين تأثيرًا في تأجيج الصراع. فهي ليست مجرد طرف داعم، بل تمتلك شراكات اقتصادية مع قوات الدعم السريع، واتصالات سياسية مع الحكومة السودانية، وأدوارًا عسكرية غير مباشرة جعلتها لاعبًا محوريًا في تحديد مسار الحرب. وهنا، يصبح من الضروري التعمق أكثر في كيف أصبحت الإمارات أحد أهم الأطراف المؤثرة في النزاع السوداني؟
الإمارات والتجارة العالمية للذهب: شبكة معقدة من المصالح

على مدى العقدين الماضيين، تحولت الإمارات العربية المتحدة إلى واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وأنظمتها المالية المرنة، وغياب الرقابة الصارمة على مصادر الذهب التي تصل إليها. في قلب هذه الشبكة المعقدة، تلعب الإمارات دورًا رئيسيًا، حيث تُعتبر سوقها نقطة جذب رئيسية للذهب القادم من إفريقيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ضعف الرقابة الاقتصادية أو النزاعات المسلحة.
يمثل الذهب 29% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، مما يجعله عنصرًا محوريًا في استراتيجيتها الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وبفضل تسهيلاتها التجارية وإعفائها الجمركي، أصبحت الإمارات الوجهة الأولى للكثير من الذهب غير الموثق القادم من الأسواق الإفريقية، حيث يتم إعادة تصديره بعد إعادة صقله وإدخاله في الأسواق المالية العالمية.
في عام 2016، استوردت الإمارات ذهبًا بقيمة 8.5 مليار دولار من 46 دولة أفريقية، متفوقة على الصين كأكبر وجهة للذهب الأفريقي. ويُستخرج الذهب الأفريقي غالبًا بطرق غير رسمية، عبر التعدين الحرفي والصغير الحجم الذي لا يخضع للإشراف الرسمي، ويتم تهريبه عبر شبكات معقدة من الوسطاء والحدود، قبل أن يصل إلى الإمارات. يُقدر حجم الذهب غير الموثق الذي استوردته الإمارات في 2016 بحوالي 67 طنًا، أي ما يعادل 3.9 مليار دولار.
لكن هذه الهيمنة لم تأتِ بدون ثمن، إذ لطالما تعرضت الإمارات لانتقادات دولية بسبب دورها في استيراد الذهب الملوث بالنزاعات، والذي غالبًا ما يكون مستخرجًا بشكل غير قانوني أو مرتبطًا بتمويل ميليشيات مسلحة، كما هو الحال في السودان. وهنا يبرز السؤال: كيف أصبح السودان إحدى أهم مصادر الذهب للإمارات؟
كيف أصبح السودان أحد أهم مصادر الذهب للإمارات؟
على الرغم من أن السودان يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة، إلا أنه يُعد أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، حيث يمثل التعدين مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في البلاد. وبسبب ضعف الرقابة، والصراعات المسلحة، وتغلغل الأفراد والجماعات غير الرسمية في قطاع التعدين، تحول الذهب إلى أحد أهم العوامل التي تؤجج الحرب الحالية.

١. السودان كأحد كبار منتجي الذهب في إفريقيا
يُقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بعشرات الأطنان، مما يجعله منافسًا لدول مثل جنوب إفريقيا وغانا. ولكن على عكس هذه الدول، يعاني السودان من ضعف البنية التحتية المالية والتنظيمية، مما أدى إلى أن جزءًا كبيرًا من إنتاجه لا يتم تصديره عبر القنوات الرسمية، بل يُهرب إلى الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات. يُشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 80% من صادرات الذهب السوداني تتجه إلى الإمارات، حيث يتم إعادة تصديره أو بيعه في الأسواق العالمية. هذه الأرقام تجعل الإمارات المستفيد الأكبر من الذهب السوداني، سواء عبر الاستيراد الرسمي أو من خلال عمليات التهريب غير القانونية.
٢. دور الإمارات في تسهيل تجارة الذهب السوداني
بدلًا من أن تعمل الإمارات على ضبط تجارة الذهب القادمة من مناطق النزاع، فإنها توفر بيئة مواتية لتدفقه عبر شركات غامضة تعمل دون رقابة فعلية. بعض الطرق التي ساهمت بها الإمارات في تسهيل تهريب الذهب السوداني تشمل:
- عدم فرض رقابة صارمة على واردات الذهب، مما يسمح بإدخال الذهب السوداني إلى دبي دون الحاجة إلى إثبات مصدره.
- استخدام السوق الإماراتية لإضفاء الشرعية على الذهب غير الموثق، حيث يتم بيعه وإعادة تصديره كمعدن نقي لا يحمل أي ارتباط بالصراعات.
- التعامل مع رجال أعمال سودانيين متحالفين مع قوات الدعم السريع، والذين يستخدمون شبكات مالية معقدة لنقل الأموال وشراء الأسلحة.
٣. العلاقة بين قوات الدعم السريع وتهريب الذهب
لا يمكن فهم القوة العسكرية والسياسية لقوات الدعم السريع دون التطرق إلى الذهب كمصدر رئيسي لتمويلها. فمنذ أن بدأ حميدتي في بناء قواته، أدرك أن الاعتماد على التمويل الحكومي وحده لن يكون كافيًا لضمان استقلالية قواته، لذا سعى إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية التي تمنحه القدرة على المناورة في الساحة السياسية والعسكرية السودانية، وكان الذهب الركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية.
السيطرة على مناجم الذهب: كيف بنت قوات الدعم السريع اقتصادها الخاص؟
مع اتساع نفوذ قوات الدعم السريع بعد إعادة هيكلتها رسميًا في 2013، بدأ حميدتي في الاستحواذ على مناجم الذهب في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق. لم يكن هذا الأمر وليد المصادفة، بل كان نتيجة تفاهمات بينه وبين النظام الحاكم آنذاك، حيث مُنح الضوء الأخضر للسيطرة على هذه المناطق مقابل ولائه للبشير. في عام 2017، حصلت شركة "الجنيد"، المملوكة لعائلة حميدتي، على تراخيص رسمية لتعدين الذهب وبيعه. لكن هذه التراخيص لم تكن سوى واجهة قانونية لتغطية عمليات أكبر بكثير من مجرد التعدين التقليدي. فخلف الكواليس، كانت قوات الدعم السريع تستخدم نفوذها العسكري لفرض سيطرتها على المناجم، وطرد المجتمعات المحلية منها، والاستيلاء على الإنتاج بالكامل.
كيف يُستخدم الذهب في تمويل العمليات العسكرية؟
من خلال بيع الذهب في السوق السوداء أو تهريبه إلى الخارج، تمكنت قوات الدعم السريع من بناء شبكة تمويل مستقلة تمامًا عن الدولة، ما منحها القدرة على:
- شراء الأسلحة الحديثة: تقارير دولية كشفت أن الدعم السريع استخدم عائدات الذهب لشراء أسلحة متطورة من السوق السوداء، وعبر وسطاء إقليميين.
- استقطاب المقاتلين وتمويل رواتبهم: مقارنة بالجيش السوداني، تقدم قوات الدعم السريع رواتب أعلى بكثير، مما جعلها قادرة على جذب المقاتلين وإغراء الشباب بالانضمام إلى صفوفها.
- التوسع في النفوذ السياسي: لم يقتصر استخدام الذهب على الجانب العسكري فقط، بل استُخدم في تمويل حملات سياسية داخل السودان، وشراء ولاءات زعماء قبائل، وحتى بناء تحالفات خارجية مع دول مثل الإمارات.
وجود مصدر تمويل مستقل مثل الذهب يعني أن قوات الدعم السريع لم تكن مضطرة للبحث عن حلول سياسية أو القبول بتسويات لا تتناسب مع طموحاتها. على العكس، كانت قادرة على إطالة أمد الحرب، لأنها لم تكن بحاجة إلى موارد الدولة أو انتظار دعم خارجي مشروط. وهذا ما جعل الذهب عاملًا رئيسيًا في استمرار الصراع، فبينما كان الجيش السوداني يعتمد على مؤسسات الدولة والتمويل الرسمي، كان الدعم السريع يستخدم اقتصاده الموازي لتمويل نفسه بشكل أكثر كفاءة، ما منحه تفوقًا في بعض الجوانب، خصوصًا في سرعة شراء المعدات العسكرية وتجنيد الأفراد.
ولم تكن قوات الدعم السريع لتتمكن من استغلال الذهب بهذا الشكل لولا وجود شبكات إقليمية ودولية ساعدت في تهريبه وإدخاله إلى الأسواق العالمية. وهنا ظهر الدور المحوري للإمارات، التي أصبحت المستورد الأول للذهب السوداني، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال السوق السوداء. ويعني هذا أن كل أوقية ذهب خرجت من السودان بطرق غير رسمية، ساهمت بشكل مباشر في تغذية آلة الحرب وإطالة أمد النزاع. وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم: ما هي الأبعاد الاستراتيجية لدور الإمارات في السودان وإفريقيا؟
الأبعاد الاستراتيجية لدور الإمارات في السودان وأفريقيا والمخاوف المرتبطة بها

لا يقتصر الدور الإماراتي في السودان على كونه عاملًا اقتصاديًا يرتبط بتجارة الذهب، بل يتجاوز ذلك ليشمل استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فمن خلال الاستثمارات الاقتصادية، والتدخلات العسكرية غير المباشرة، والتحالفات السياسية، تسعى الإمارات إلى ترسيخ وجودها كلاعب رئيسي في المعادلة الأقليمية، بما يخدم مصالحها الأوسع في المنطقة. تسعى الإمارات إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، حيث يُعتبر السودان مركزًا محوريًا لهذه الاستراتيجية بفضل موقعه الجغرافي الحيوي وموارده الطبيعية. يهدف التدخل الإماراتي في السودان إلى تأمين طرق الملاحة البحرية الهامة وضمان السيطرة على سلاسل التوريد الغذائية، في ظل سعي الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
تُظهر الإمارات نهجًا براغماتياً في سياستها الخارجية من خلال دعمها لقوى مسلحة محلية تعمل على تعزيز نفوذها الإقليمي. هذا النهج لم يقتصر على السودان، بل ظهر بشكل واضح في تدخلها في النزاعات في كل من اليمن وليبيا. في اليمن، قامت الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تعتبر حليفًا للإمارات، مما أتاح لها السيطرة على مناطق استراتيجية مثل عدن وسقطرى. وتعمل الإمارات على تعزيز نفوذها على الموانئ والممرات المائية اليمنية بهدف تأمين طرق الملاحة وتعزيز موقعها الجيوسياسي.
أما في ليبيا، فقد دعمت الإمارات قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، سواء عبر التمويل المالي أو من خلال توفير الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الليبية. وقد ساهم هذا الدعم في تعزيز موقف حفتر في الحرب الأهلية الليبية ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
بالإضافة إلى السودان، تتطلع الإمارات إلى تعزيز استثماراتها في بلدان أفريقية أخرى، مثل إثيوبيا، وكينيا، وأنغولا، وزيمبابوي، وتنزانيا. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تطوير مشاريع زراعية وتجارية تسهم في تصدير المنتجات الغذائية إلى الإمارات. فعلى سبيل المثال، تعاونت الإمارات في أنغولا مع شركات محلية لتطوير أراضٍ بمساحة تعادل 9,300 ملعب كرة قدم، بهدف إنتاج 28 ألف طن من الأرز و5,500 طن من الأفوكادو خلال 18 شهرًا. وفي كينيا، استثمرت الإمارات عبر صندوق ADQ بما يصل إلى 500 مليون دولار في قطاعات الزراعة والغذاء، مما يعكس حرصها على تعزيز إمداداتها الغذائية من القارة الأفريقية.
إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد، تعزز هذه الاستثمارات نفوذ الإمارات في القارة الأفريقية وتمكنها من تأمين خطوط تجارية هامة، لا سيما في مناطق البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتحاول الإمارات من خلال بناء شبكة اقتصادية قوية في أفريقيا، ضمان التدفق السلس للمنتجات الغذائية والمواد الأولية، ما يدعم استراتيجيتها لتنويع مصادر دخلها وتثبيت مكانتها في الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، فإن هذا التوسع الاستراتيجي يثير العديد من المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية الأفريقية. يُخشى أن يتم تخصيص الأراضي الخصبة لإنتاج محاصيل معدة للتصدير بدلاً من تلبية احتياجات السكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف حول الشفافية في عمليات الاستثمار وحقوق المزارعين والعمال المحليين الذين قد يعملون في ظروف صعبة، سواء في بلدانهم أو عند انتقالهم للعمل في الخليج.
السودان كنقطة ارتكاز في استراتيجية الإمارات الإفريقية
تدرك الإمارات أن السودان ليس مجرد بلد غني بالموارد، بل هو محور رئيسي في معادلة النفوذ الإقليمي. فموقعه الجغرافي يجعل منه نقطة عبور بين شمال إفريقيا وجنوبها، وممرًا تجاريًا مهمًا بين البحر الأحمر ووسط القارة، ما يمنحه أهمية استراتيجية تفوق موارده الاقتصادية.
البحر الأحمر
لا يمكن فهم الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في السياسة الإماراتية بمعزل عن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة. فالحديث عن البحر الأحمر لا يقتصر فقط على كونه ممراً لصادرات النفط، بل يتجاوزه ليشمل إستراتيجية أوسع تهدف إلى تأمين النفوذ الإماراتي في أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على مستوى العالم. فهو يُعد أحد أهم الممرات البحرية التي تربط الخليج العربي بالأسواق العالمية في أوروبا وإفريقيا، حيث تمر عبره حوالي 12% من حجم التجارة العالمية، مما يجعله شرياناً اقتصادياً لا يمكن لأي قوة إقليمية تجاهله. ومن هذا المنطلق، تدرك الإمارات أن ضمان النفوذ على سواحله يعني السيطرة على التدفقات التجارية الأساسية التي يعتمد عليها اقتصادها، سواء في التصدير أو الاستيراد. بجانب النفط، تعتمد الإمارات بشكل كبير على التجارة وإعادة التصدير كنشاط اقتصادي رئيسي. فميناء جبل علي في دبي هو واحد من أكبر الموانئ التجارية في العالم، وهو يعتمد على حركة الملاحة البحرية النشطة عبر البحر الأحمر لضمان تدفق السلع من وإلى الأسواق الإفريقية والأوروبية. لذا، فإن أي اضطراب أمني في هذا الممر البحري يمكن أن يعرض تجارة الإمارات لاضطرابات خطيرة، ما يجعل الحفاظ على استقراره ضرورة اقتصادية ملحة.
والبحر الأحمر لم يكن أبداً مجرد طريق تجاري مفتوح، بل كان دائماً ساحة صراع بين القوى الدولية والإقليمية التي تتنافس على النفوذ في هذه المنطقة الحيوية. ومع صعود قوى مثل تركيا وقطر والصين كلاعبين اقتصاديين في إفريقيا، رأت الإمارات أن وجودها في البحر الأحمر أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على موقعها كقوة تجارية رائدة. فالتحركات الإماراتية في البحر الأحمر لم تقتصر على السودان فقط، بل امتدت إلى القرن الإفريقي بأكمله، حيث استثمرت الإمارات بشكل كبير في الموانئ والبنية التحتية البحرية لتعزيز نفوذها الإقليمي وتأمين مصالحها التجارية والعسكرية. ففي جيبوتي، كانت الإمارات تدير ميناء دوراليه للحاويات من خلال شركة موانئ دبي العالمية، ولكن بعد خلاف سياسي في 2018، فقدت الإمارات سيطرتها على الميناء عندما قررت الحكومة الجيبوتية إنهاء عقدها، وهو ما دفع الإمارات إلى البحث عن بدائل أخرى لتعزيز وجودها في البحر الأحمر. انتقلت بعد ذلك إلى إريتريا، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مكّنتها من إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء عصب، الذي تحول إلى أحد أهم المراكز اللوجستية للإمارات خلال حرب اليمن، إذ استخدمته كنقطة انطلاق لنقل القوات والمعدات العسكرية لدعم التحالف العربي. وتشير التقارير إلى أن القاعدة الإماراتية في عصب تضم مدارج للطائرات الحربية وطائرات الدرون، بالإضافة إلى مراكز تدريب عسكرية، ما يعكس تحول الوجود الإماراتي في البحر الأحمر من مجرد استثمارات اقتصادية إلى حضور عسكري استراتيجي دائم. أما في الصومال، فقد دخلت الإمارات بقوة من خلال اتفاقيات لإنشاء وإدارة موانئ في مدن مثل بربرة وبوصاصو عبر شركة موانئ دبي العالمية، ما أثار حفيظة الحكومة الصومالية، التي اعتبرت هذه الاتفاقيات انتهاكًا لسيادتها الوطنية، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الإمارات استمرت في تعزيز نفوذها عبر دعم حكومات محلية، وتمويل قوات أمنية موالية لها، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في أمن البحر الأحمر. ويعكس هذا التوسع الإماراتي في القرن الإفريقي رغبتها في بناء شبكة نفوذ إقليمي تمتد من الخليج العربي وصولًا إلى القرن الإفريقي، بما يضمن لها السيطرة على أحد أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم.

وسط هذا التنافس، يُعد السودان أحد المفاتيح الأساسية في إستراتيجية الإمارات تجاه البحر الأحمر، إذ يمتلك ساحلًا يمتد لحوالي 700 كيلومترًا. هذا الامتداد الساحلي يمنح السودان إمكانية الوصول إلى أهم طرق التجارة البحرية، ما يجعله نقطة جذب للقوى الإقليمية والدولية التي تتنافس على تعزيز نفوذها في المنطقة. وعلى الرغم من أن السودان يمتلك عدة موانئ رئيسية مثل بورتسودان وسواكن، إلا أن بنيته التحتية البحرية تعاني من إهمال طويل ونقص في الاستثمارات، ما جعله مرشحًا طبيعيًا للاستثمارات الخارجية، خصوصًا من دول مثل الإمارات التي ترى فيه فرصة لتعزيز سيطرتها على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
لهذا السبب، سعت الإمارات إلى تعزيز علاقاتها مع الفاعلين السياسيين والعسكريين في السودان لضمان بقاء نفوذها على الساحل السوداني، بغض النظر عن طبيعة السلطة الحاكمة. وقد انعكس هذا بوضوح في محاولاتها المستمرة للاستثمار في ميناء بورتسودان، الذي يُعد أكبر موانئ السودان، حيث تمر عبره أكثر من 90% من حركة الصادرات والواردات السودانية، مما يجعله الرئة الاقتصادية الأساسية للبلاد. ففي عام 2017، دخلت شركة موانئ دبي العالمية في مفاوضات مع الحكومة السودانية لتطوير وإدارة الميناء، لكن هذه المحادثات تعثرت بسبب خلافات سياسية وضغوط داخلية، حيث رأت بعض الأطراف السودانية أن منح الإمارات حق إدارة الميناء قد يؤدي إلى فقدان السودان سيادته الاقتصادية على ممره البحري الرئيسي، ما أثار مخاوف لدى القوى الوطنية والقيادات المحلية في شرق السودان من أن تتحول هذه الاستثمارات إلى سيطرة إماراتية مباشرة، لا تراعي المصالح الوطنية أو الاحتياجات التنموية للمنطقة.
ومع سقوط نظام البشير في 2019، جددت الإمارات محاولاتها، مستخدمة نفوذها الاقتصادي والسياسي لإعادة إحياء الصفقة، لكنها واجهت مقاومة قوية من النقابات العمالية، والقيادات الوطنية، وزعماء شرق السودان الذين رفضوا أي ترتيبات قد تضع الميناء تحت إدارة أجنبية طويلة الأمد. ورغم تعثر المفاوضات رسميًا، لم تتوقف الجهود الإماراتية، حيث استمرت في توثيق علاقاتها مع شخصيات نافذة داخل السلطة الانتقالية، مما جعل مستقبل الموانئ السودانية موضع جدل دائم.
ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 2023، ازدادت المخاوف من أن يتم استغلال حالة الفوضى لإعادة طرح فكرة السيطرة الإماراتية على الموانئ، خاصة مع اعتماد الحكومة السودانية على الدعم الخارجي للحفاظ على استقرار الاقتصاد. وفي هذا السياق، لعبت المخاوف من الهيمنة على المرافق الساحلية دورًا هاما في قرار الجيش السوداني نقل مركز قيادته وعاصمته الإدارية مؤقتًا إلى بورتسودان خلال الحرب، في خطوة تعكس إدراك القيادة العسكرية لأهمية المدينة ليس فقط كملاذ آمن من الاشتباكات في الخرطوم، ولكن أيضًا كرمز للسيادة السودانية على البحر الأحمر، وسط التنافس الدولي والإقليمي المتزايد على المنطقة.
كيف تستخدم الإمارات الاستثمارات كأداة للنفوذ في السودان وإفريقيا؟
لم يكن اهتمام الإمارات بالسودان قائمًا فقط على موقعه الاستراتيجي أو موانئه البحرية، بل كان جزءًا من رؤية اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذها عبر الاستثمارات والتمويل، مما يمنحها تأثيرًا يتجاوز الاقتصاد ليشمل السياسة والأمن الإقليمي. فمن خلال الاستحواذ على قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والبنية التحتية، والتجارة، والتعدين والطاقة، عملت الإمارات على فرض واقع اقتصادي يجعل السودان أكثر ارتباطًا بها، وهو ما يضمن لها نفوذًا طويل الأمد، لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد ليشمل مناطق أوسع في إفريقيا.
في القطاع الزراعي، كانت الإمارات من أوائل الدول التي أدركت القيمة الاستراتيجية للأراضي السودانية الخصبة، خاصة مع معاناتها من شح الموارد الزراعية والمياه. ومع امتلاك السودان أكثر من 175 مليون فدان من الأراضي الزراعية الصالحة للاستثمار، أصبح هدفًا رئيسيًا للاستثمارات الإماراتية في هذا المجال. خلال العقدين الماضيين، استحوذت شركات إماراتية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية السودانية من خلال اتفاقيات طويلة الأمد. من أبرز هذه الشركات "مجموعة الظاهرة الزراعية" التي تعمل في إنتاج القمح والأعلاف وتوجه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى الأسواق الإماراتية بدلًا من تغذية السوق السوداني، ففي عام 2022، حصلت الشركة على مشروع وادي الهواد بمساحة تقارب 3 ملايين فدان، بقيمة استثمارية أولية تبلغ حوالي مليار دولار، مع توقع وصول إجمالي الاستثمارات إلى نحو 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى. لم تكن هذه الاستثمارات مجرد نشاط تجاري، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية تأمين الغذاء للإمارات، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد السوداني، حيث أدى تحويل الإنتاج نحو التصدير إلى نقص حاد في بعض المحاصيل داخل السودان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل غياب سياسات رقابية تضمن تحقيق توازن بين الاستثمارات الأجنبية والاحتياجات المحلية.
لم يكن النفوذ الإماراتي في السودان قائمًا على الاستثمارات وحدها، بل تم استخدامه كأداة ضغط سياسي لضمان تبعية السودان للسياسات الإقليمية الإماراتية. فقدمت الإمارات دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة السودانية بقيادة قوى الحرية والتغيير، خلال الفترة الانتقالية، لكن هذا الدعم لم يكن دون مقابل، حيث ارتبط بشروط سياسية تتماشى مع الأجندة الإماراتية، سواء فيما يتعلق بالتحالفات الإقليمية أو التوازنات الداخلية. كما استخدمت الإمارات استثماراتها للتأثير على التوجهات الاقتصادية للسودان، من خلال توجيه العقود لصالح شركاتها ومنع دخول استثمارات منافسة من دول أخرى، خاصة تركيا وقطر، اللتين كانتا تسعيان إلى تعزيز نفوذهما الاقتصادي في السودان عبر استثمارات في البنية التحتية والزراعة.
بهذا النهج، لم تكن الاستثمارات الإماراتية في السودان مجرد دعم اقتصادي، بل تحولت إلى وسيلة لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي وفق رؤية تخدم مصالح أبوظبي على المدى الطويل. وبينما يحتاج السودان إلى استثمارات أجنبية لدفع اقتصاده نحو النمو، يظل التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق هذا النمو دون الوقوع في فخ التبعية المطلقة، حيث تتحول الاستثمارات إلى أدوات للسيطرة بدلاً من أن تكون محفزًا للتنمية المستقلة.
لم تقتصر الاستثمارات الإماراتية على السودان فحسب، بل امتدت إلى أنحاء القارة الإفريقية، حيث سعت أبوظبي إلى بسط نفوذها عبر مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الطاقة، والبنية التحتية، مما جعل السودان حلقة أساسية في شبكة نفوذ مترابطة تربط بين القرن الإفريقي، شمال إفريقيا، وغرب القارة. السودان بالنسبة للإمارات ليس مجرد سوق للاستثمار، بل هو نقطة عبور حيوية تسهّل تدفق التجارة والموارد بين هذه المناطق، مما يمنح الإمارات نفوذًا واسعًا يمتد من البحر الأحمر إلى الأطلسي.
كان القطاع الزراعي أحد أبرز الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتعزيز نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، حيث لم يكن الاستثمار في هذا المجال مجرد محاولة لتحقيق الأمن الغذائي، بل كان جزءًا من إستراتيجية أوسع للهيمنة على الموارد الزراعية وضمان تدفق الإنتاج إلى أسواقها. في أنغولا، دخلت شركات إماراتية مثل "دبي للاستثمار" و"إي 20 إنفستمنتس" في عام 2023 في مشاريع زراعية كبرى لاستغلال آلاف الهكتارات في زراعة الأرز والأفوكادو، مما منحها قدرة على التحكم في إنتاج وتوزيع المحاصيل الاستراتيجية داخل إفريقيا وخارجها. وفي كينيا، خصصت الإمارات عبر "مجموعة الظاهرة الزراعية" استثمارات تُقدَّر بحوالي 800 مليون دولار في فبراير 2025 لتشغيل وإدارة مساحات زراعية شاسعة، مما يضع أبوظبي في موقع قوي لتحديد كيفية استخدام هذه الأراضي، وأي الأسواق تحصل على الإنتاج الزراعي. أما في إثيوبيا، فقد توسعت الإمارات في دعم مشاريع الري الكبرى منذ 2018 تحت غطاء تنموي، في حين أن الهدف الأساسي كان ضمان استقرار إنتاج المحاصيل الموجهة إلى الأسواق الخليجية، وتعزيز سيطرة الإمارات على سلاسل التوريد الزراعية في شرق إفريقيا. هذه المشاريع، التي تبدو في ظاهرها استثمارات اقتصادية، تكشف عن نمط واضح تتبعه الإمارات في مختلف الدول الإفريقية، حيث تستخدم رؤوس الأموال ليس فقط لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ولكن أيضًا لتأمين أدوات ضغط جيوسياسية تمكنها من التحكم في تدفق الموارد الزراعية وفقًا لمصالحها، وهو ما يفسر سعيها المستمر لضمان السيطرة على السودان، الذي يُعد البوابة الأهم لهذه الاستثمارات ونقطة العبور الأساسية للموارد القادمة من شرق ووسط إفريقيا.

أما قطاع الطاقة والتعدين، فقد كان مجالًا آخر استثمرت فيه الإمارات بقوة، فخلال السنوات 2018-2025، برزت الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر المستثمرين في إفريقيا، حيث أعلنت عن مشاريع بقيمة 110 مليارات دولار بين عامي 2019 و2023، منها 72 مليار دولار مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة. في مجال التعدين، وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير أربعة مناجم للمعادن الهامة. كما تم التخطيط لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في أبوظبي، وهو الأول من نوعه في المنطقة. وفي كينيا، وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة والتخطيط الكينية في أبريل 2024 لتطوير قطاعي التعدين والتكنولوجيا، مع التزام استثماري يصل إلى 500 مليون دولار.
هذه الاستثمارات الواسعة في إفريقيا، وخاصة في مجالات الطاقة والتعدين، تُظهر استراتيجية الإمارات لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي في القارة. يُعتبر السودان محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يجعله حلقة وصل بين الاستثمارات الإماراتية في مختلف أنحاء إفريقيا وأسواق الشرق الأوسط. تُعزز السيطرة على السودان قدرة الإمارات على تأمين تدفق الموارد الطبيعية وضمان استدامة مشاريعها الاستثمارية في القارة.
السودان، بموقعه الجغرافي ومصادره الطبيعية، أصبح حلقة الوصل التي تربط بين هذه الاستثمارات، فالموانئ السودانية تؤمن طريقًا مباشرًا للصادرات القادمة من غرب إفريقيا باتجاه الخليج والأسواق الآسيوية، بينما تربط الاستثمارات الزراعية في السودان بين مشاريع الري في إثيوبيا ومزارع الإنتاج في كينيا، مما يعزز التكامل في سلسلة التوريد الإماراتية عبر القارة. بهذا الشكل، تحول السودان من مجرد بلد مستهدف بالاستثمارات إلى محور استراتيجي يخدم مشروعًا إماراتيًا أوسع، يهدف إلى السيطرة على الموارد الإفريقية وتأمين تدفقها إلى الأسواق الإماراتية وفق رؤية اقتصادية تضمن تفوق أبوظبي التجاري في المنطقة.
مصادر المعلومات: (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11)
الدعم العسكري واللوجستي: ما وراء الكواليس
مع اشتداد حدة الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برزت العديد من التقارير التي تتحدث عن دور خارجي في تأجيج النزاع، حيث ظهرت الإمارات كأحد أكثر الفاعلين تأثيرًا في مسار الحرب. لم يقتصر هذا التأثير على الأبعاد الاقتصادية والسياسية فقط، بل امتد ليشمل دعمًا عسكريًا ولوجستيًا لقوات الدعم السريع، مما ساهم في استمرار القتال وتعزيز قدرة هذه القوات على مواجهة الجيش السوداني في حرب مفتوحة.
لم يكن هذا التدخل العسكري المباشر أمرًا جديدًا في السياسة الخارجية الإماراتية، إذ سبق أن لعبت أدوارًا مشابهة في ليبيا واليمن، حيث دعمت فصائل مسلحة للحفاظ على نفوذها في مناطق استراتيجية. لكن في السودان، أخذ هذا التدخل بعدًا أكثر تعقيدًا، إذ لم يقتصر الدعم الإماراتي على تسليح قوات الدعم السريع، بل شمل توفير شبكة لوجستية متكاملة، تشمل الإمدادات العسكرية، وتأمين خطوط تهريب الأسلحة، والدعم الاستخباراتي، فضلًا عن استغلال القنوات الإعلامية لصياغة الرواية التي تبرر استمرار النزاع وتُضعف الموقف السياسي للجيش السوداني.
في هذا القسم، سنتناول كيف قدمت الإمارات الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، ونحلل تأثيره على توازن القوى في الحرب، كما سنقارن هذا الدور بالتدخلات الإماراتية السابقة في مناطق النزاع الأخرى مثل ليبيا واليمن، ونناقش كيف تسهم الحرب الإعلامية في ترسيخ مصالح الإمارات داخل السودان.

كيف ساهمت الإمارات في تسليح وتعزيز قدرات قوات الدعم السريع؟
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تصاعدت التقارير حول دور الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالإمدادات العسكرية واللوجستية، سواء عبر شحنات مباشرة أو من خلال شبكات تهريب منظمة تمتد عبر تشاد وليبيا. وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر أواخر عام 2023، تم تهريب شحنات أسلحة متطورة، تشمل بنادق قنص، وطائرات مسيرة، وعربات مدرعة، إلى السودان، حيث وصلت إلى قوات الدعم السريع عبر طرق غير رسمية تمر عبر الحدود مع تشاد. وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الإمارات استخدمت شركات خاصة لضمان نقل هذه الإمدادات، مما يتيح لها تقديم الدعم دون ترك أدلة رسمية على تدخلها المباشر.

قاعدة الإمداد في تشاد: دور لوجستي إماراتي خفي
إلى جانب شحنات الأسلحة، تركزت العمليات اللوجستية الإماراتية في شمال تشاد، حيث تشير مصادر متعددة إلى أن الإمارات وفرت معدات وذخائر لقوات الدعم السريع من خلال قاعدة عسكرية هناك. وفقًا لتحقيقات صحفية، تم استخدام هذه القاعدة منذ يونيو 2023 كمركز لتأمين الإمدادات اليومية، إذ زعمت الإمارات أن العملية ذات طابع إنساني، لكن العديد من التقارير ربطت هذه الرحلات الجوية بشحنات عسكرية كانت تصل إلى قوات الدعم السريع. كما وثقت مصادر أمنية غربية وجود رحلات يومية تنقل معدات عسكرية خفيفة وثقيلة من القاعدة في تشاد إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع داخل السودان.
الوجود العسكري الإماراتي المباشر في السودان
في تطور أكثر خطورة، ظهرت تقارير تتحدث عن وجود عسكري إماراتي مباشر داخل السودان، ما يشير إلى دور أعمق من مجرد الدعم اللوجستي. ففي أواخر سبتمبر 2024، أعلنت الإمارات عن مقتل أربعة من جنودها في السودان، لكنها لم تكشف عن تفاصيل المهمة التي كانوا يؤدونها أو سبب وجودهم في ساحة القتال. في السياق نفسه، أشارت تقارير استخباراتية أخرى إلى أن الجيش السوداني استهدف غرفة عمليات تابعة لقوات الدعم السريع في مطار نيالا، ما أدى إلى مقتل أو إصابة 13 من الجنود الإماراتيين والمقاتلين المتحالفين معهم. هذا الهجوم كشف عن وجود وحدات إماراتية ميدانية داخل السودان، وهو أمر لم تعترف به الإمارات رسميًا.

أدلة ميدانية على التدخل الإماراتي
لم تقتصر المؤشرات على التقارير الاستخباراتية، بل شملت أدلة ميدانية تثبت تورط الإمارات في النزاع بشكل مباشر. فقد تم العثور على جوازات سفر إماراتية في مناطق الاشتباك داخل السودان، ما يعزز فرضية وجود عناصر إماراتية تقاتل إلى جانب قوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير استخباراتية أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة معدلة، تم استخدامها لإلقاء القنابل الحرارية على مواقع الجيش السوداني، مما منح قوات الدعم السريع تفوقًا تكتيكيًا في عدة معارك، خاصة في المناطق الحضرية.
دعم يتجاوز ليبيا واليمن: تصعيد غير مسبوق
يُظهر هذا التدخل العسكري الإماراتي في السودان نهجًا مشابهًا لما حدث في ليبيا واليمن، لكن مع تصعيد غير مسبوق. ففي ليبيا، دعمت الإمارات قوات خليفة حفتر عبر إرسال شحنات أسلحة ومسيّرات تركية الصنع، بينما قدمت دعمًا عسكريًا للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لتعزيز نفوذها على الموانئ الاستراتيجية هناك. أما في السودان، فالتدخل لم يقتصر على التسليح والتمويل، بل امتد إلى وجود مباشر لعناصر إماراتية على الأرض، ما يطرح تساؤلات حول مدى تورط أبوظبي في تأجيج الصراع، وما إذا كانت تسعى إلى تحقيق أهداف تتجاوز مجرد النفوذ الاقتصادي، لتشمل إعادة تشكيل الخريطة السياسية والعسكرية للسودان بما يخدم مصالحها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
مصادر المعلومات (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6)
الحرب المعلوماتية ودور الإمارات في التأثير الإعلامي

لم يكن التدخل الإماراتي في السودان مقتصرًا على الدعم العسكري أو الاقتصادي، بل امتد إلى مجال الحرب المعلوماتية، حيث لعبت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية دورًا محوريًا في توجيه السردية حول الصراع السوداني، بما يخدم المصالح الإماراتية. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، برزت قنوات إماراتية مثل سكاي نيوز عربية كأداة رئيسية لتغطية النزاع، مع تبني خطاب إعلامي يميل إلى تبرير تحركات قوات الدعم السريع وتقديمها كقوة نظامية قادرة على فرض الاستقرار، بينما يتم تصوير الجيش السوداني كطرف غير قادر على إدارة المرحلة الانتقالية، مما يعكس محاولة إعادة تشكيل الرأي العام السوداني والدولي تجاه أطراف النزاع.
استخدمت الإمارات أيضًا شبكاتها الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لتوجيه دفة النقاش حول الحرب، حيث كشفت تقارير عن تمويلها حملات رقمية تهدف إلى التأثير على الرأي العام المحلي والدولي. هذه الحملات تضمنت نشر محتوى مضلل، وتقارير مشوهة حول الأحداث الميدانية، بهدف التأثير على موقف القوى الدولية والإقليمية تجاه الأزمة السودانية. في هذا السياق، أُشير إلى وجود حسابات إلكترونية تعمل على ترويج سرديات معينة تخدم أجندة أبوظبي، حيث تم رصد نشاط مكثف لمنصات تابعة لشركات علاقات عامة إماراتية تعمل على تحسين صورة قوات الدعم السريع في الأوساط الغربية، مع محاولة شيطنة الجيش السوداني عبر التركيز على مزاعم بانتهاكاته لحقوق الإنسان.
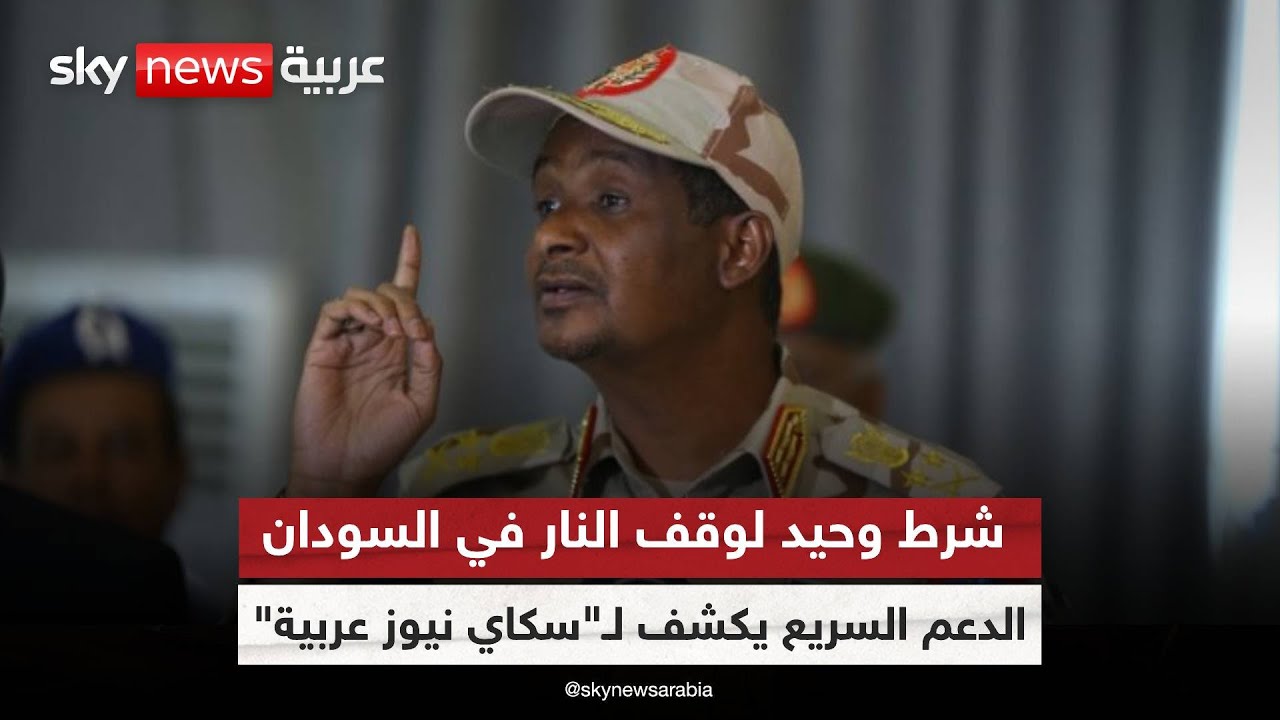
أحد أبرز الأمثلة على استخدام الإمارات للإعلام كأداة نفوذ كان في سبتمبر 2024، عندما اتهمت أبوظبي الجيش السوداني بتنفيذ هجوم جوي على مقر بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم، وهو ما نفته الحكومة السودانية رسميًا، مؤكدة التزام الجيش بالقانون الدولي. ورغم عدم وجود أدلة قاطعة تدعم الادعاء الإماراتي، إلا أن وسائل الإعلام الإماراتية استخدمت الحادثة للترويج لسردية تفيد بأن الجيش السوداني يستهدف البعثات الدبلوماسية، مما أدى إلى إدانات عربية ودولية واسعة، في خطوة اعتُبرت جزءًا من الاستراتيجية الإعلامية الإماراتية لتقويض شرعية الجيش السوداني على المستوى الدولي.
لم يقتصر التأثير الإعلامي الإماراتي على التغطية الإخبارية التقليدية، بل امتد ليشمل الضغوط الدبلوماسية عبر المنصات الدولية، إلى جانب توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار المضللة وتوجيه الرأي العام. فقد كشفت تقارير عن حملات إعلامية مكثفة على تويتر وفيسبوك تستهدف إضفاء الشرعية على قوات الدعم السريع، والترويج لسرديات تُظهر حميدتي كشريك موثوق للمجتمع الدولي، مقابل اتهام الجيش السوداني بالتسبب في الفوضى الأمنية.
هذه الاستراتيجية الإعلامية تتسق مع النهج الذي اتبعته الإمارات في مناطق نزاع أخرى، مثل ليبيا واليمن، حيث استخدمت الإعلام الموجه كأداة لدعم حلفائها، والتأثير على مخرجات النزاع بما يخدم مصالحها الاستراتيجية. في السودان، لم يكن الإعلام مجرد ناقل للأخبار، بل تحول إلى سلاح فعّال ضمن معركة النفوذ التي تدور في الخفاء، مما يجعل الحرب المعلوماتية جزءًا أساسيًا من الصراع، إلى جانب المواجهات العسكرية والضغوط السياسية.
مصادر المعلومات (1 - 2 - 3 - 4)
الموقف الدولي من التدخل الإماراتي في السودان
مع تصاعد الدور الإماراتي في الحرب السودانية، تباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية بين التجاهل، والإدانة الصامتة، والتحركات المحدودة. فرغم التقارير المتكررة التي تؤكد دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بالسلاح والتمويل، لم تتخذ الدول الكبرى خطوات فعلية لمحاسبتها أو الحد من تدخلها، ما يعكس توازنات معقدة تحكم المشهد السياسي والدبلوماسي.
الموقف الأمريكي والأوروبي: بيانات بلا أفعال
منذ اندلاع الحرب في السودان، أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات تدين العنف، لكنها تجنبت توجيه اتهامات مباشرة للإمارات. في مايو 2024، نشرت واشنطن بوست تقريرًا يكشف تورط أبوظبي في إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر طرق غير رسمية، ما دفع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي للمطالبة بفتح تحقيق في القضية. ورغم ذلك، لم تتخذ إدارة بايدن إجراءات صارمة، نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط واشنطن بأبوظبي، والتي تشمل ملفات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود السودان.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أبدى قلقًا متزايدًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لكنه اكتفى بفرض عقوبات على أفراد من قوات الدعم السريع دون استهداف الجهات الداعمة لها. في تقرير نشرته الغارديان في يناير 2025، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن بعض الدول الأوروبية تتردد في مواجهة الإمارات بشكل مباشر، خوفًا من فقدان شراكاتها الاقتصادية وصفقات الطاقة والاستثمارات.
الموقف الأفريقي: صمت يرافقه قلق
على المستوى الأفريقي، بدت المواقف أكثر حذرًا. فالاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية السودان عقب اندلاع الحرب، لم يصدر أي إدانة رسمية للدور الإماراتي، رغم تزايد الأدلة على تورط أبوظبي في تسليح قوات الدعم السريع. دول مثل تشاد وإثيوبيا عبّرت عن مخاوفها من تداعيات الحرب على أمنها القومي، خاصة مع تدفق اللاجئين السودانيين إلى أراضيها، لكن هذه المخاوف لم تترجم إلى خطوات دبلوماسية أو سياسية ضد الإمارات. إلا أن الموقف الأخير للاتحاد الأفريقي في رفض محاولات قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، إنشاء حكومة موازية للحكومة السودانية الرسمية، يعتبر موقفا ايجابيا يساهم في وقف تمدد الأزمة وانقسام السودان. (شرق أفريقيا)

الأمم المتحدة: تقارير متكررة بلا إجراءات فعلية
منذ العام 2023، أصدرت الأمم المتحدة تقارير عدة توثق الانتهاكات في السودان، مشيرة إلى دور الإمارات في تغذية النزاع عبر تجارة الذهب وتهريب الأسلحة. في أكتوبر 2024، قدم فريق خبراء تابع للأمم المتحدة تقريرًا إلى مجلس الأمن، أكد فيه أن الإمارات تُستخدم كمنصة لتصدير الذهب السوداني غير القانوني، مما يساهم في تمويل الحرب. ومع ذلك، لم يتم تبني أي قرارات ملزمة ضد الإمارات، بسبب النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تمارسه أبوظبي داخل المنظمة الدولية.
المحصلة: ازدواجية المعايير في التعامل مع الإمارات
تكشف ردود الفعل الدولية عن تناقض واضح في التعامل مع التدخلات الخارجية في السودان. فبينما كانت هناك تحركات سريعة ضد بعض القوى الإقليمية الأخرى، ظلت الإمارات بعيدة عن العقوبات الدولية المباشرة، ما يثير تساؤلات حول مدى استعداد المجتمع الدولي لمحاسبة الدول التي تستخدم نفوذها لتأجيج النزاعات في أفريقيا.
هل يشكل التحرك القانوني للسودان ضد الإمارات سابقة خطيرة؟
مع تصاعد الأدلة على دور الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، لجأت الحكومة السودانية في مارس 2025 إلى المسار القانوني، في خطوة غير مسبوقة في العلاقات الإقليمية، حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر دعمها لقوات ارتكبت انتهاكات جسيمة في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. هذا التحرك القانوني، رغم كونه سابقة نادرة في السياسة العربية، يحمل تداعيات بعيدة المدى، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي، أو على مستوى تعامل الدول المتضررة مع التدخلات الإقليمية في المستقبل.

الأساس القانوني للدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات
تستند الدعوى التي رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية على اتهامها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تلزم الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية وعدم تقديم أي دعم للأطراف المتورطة فيها. يدعي السودان أن الإمارات لم تكتفِ بعدم منع الإبادة، بل ساهمت بشكل مباشر في تمويل وتسليح قوات الدعم السريع، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق جماعة المساليت في إقليم دارفور. تستند هذه الادعاءات إلى تقارير أممية واستخباراتية تشير إلى تورط الإمارات في تهريب الأسلحة عبر تشاد وليبيا، وتسهيل عمليات تمويل لقوات الدعم السريع من خلال تجارة الذهب السوداني، وهو ما يتعارض مع التزاماتها الدولية.
تعتبر المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية الإطار القانوني الأساسي لهذه القضية، حيث تلزم جميع الدول بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. في هذا السياق، ترى السودان أن تقديم الإمارات المساعدات العسكرية والمالية واللوجستية لقوات الدعم السريع يجعلها شريكًا في هذه الجرائم، خاصة في ظل الأدلة التي تؤكد أن هذه الميليشيا استخدمت الدعم في عمليات استهداف ممنهجة ضد المدنيين في غرب دارفور. كما تستند السودان إلى المادة الثالثة من الاتفاقية، التي تحظر أي تواطؤ أو مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الإبادة الجماعية. وهنا، يدعي السودان أن الإمارات، من خلال توفير الأسلحة والتمويل، قد ساعدت في استمرار الفظائع التي وقعت في دارفور، وبالتالي تتحمل مسؤولية قانونية دولية.
بالإضافة إلى ذلك، تستند السودان في الدعوى إلى المادة التاسعة من الاتفاقية، والتي تمنح الدول الأطراف الحق في رفع قضايا ضد أي دولة أخرى يشتبه في انتهاكها للاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية. وبما أن السودان والإمارات دولتان موقعتان على الاتفاقية، فإن المحكمة تملك الاختصاص القانوني للنظر في القضية. وفي هذا الإطار، طلب السودان من المحكمة أن تأمر الإمارات بوقف جميع أشكال الدعم العسكري والمالي لقوات الدعم السريع فورًا، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، لا سيما في غرب دارفور حيث تعرضت جماعة المساليت لمجازر وحملات تطهير عرقي موثقة.
من جانبها، رفضت الإمارات هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن دعمها للسودان كان إنسانيًا بحتًا ولم يشمل أي مساعدات عسكرية. كما اتهمت أبوظبي السودان بمحاولة تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني في الحرب. لكن على الرغم من هذا الإنكار، فإن مجرد رفع السودان لهذه الدعوى يمثل خطوة غير مسبوقة في العلاقات العربية، وقد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية وقانونية خطيرة، بما في ذلك زيادة الضغط الدولي على الإمارات، وإعادة النظر في صفقات الأسلحة والعلاقات العسكرية مع بعض الدول الغربية.
إذا قررت محكمة العدل الدولية قبول القضية، فسيكون لذلك أثر قانوني بالغ، حيث قد يُشكل سابقة تاريخية في استخدام الدول العربية للقضاء الدولي لحل نزاعاتها. كما أنه قد يفتح الباب أمام دول أخرى، مثل ليبيا واليمن، لاتخاذ مسارات مشابهة لمقاضاة الإمارات أو دول أخرى بتهم التدخل في شؤونها الداخلية. وبغض النظر عن الحكم النهائي، فإن هذه القضية تؤكد أن التدخلات الإقليمية في النزاعات الداخلية لم تعد محصنة من الملاحقة القانونية الدولية، وأن استخدام المحاكم الدولية أصبح أداة جديدة في صراعات النفوذ الإقليمية.
التأثيرات الداخلية للصراع في السودان: التهجير، فقدان الأرواح، ودور الدعم الخارجي
تفكك الحكم المدني وتعطيل الانتقال السياسي
منذ سقوط نظام عمر البشير في عام 2019، كان السودان يحاول تنفيذ عملية انتقالية نحو حكم مدني. ومع ذلك، أدى الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات إلى تعطيل هذه الجهود، ما أدى إلى إضعاف فرص إنشاء حكومة مدنية قادرة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تبرز أهمية دعم الإمارات لقوات الدعم السريع من حيث قدرته على تعزيز قوة هذه الميليشيات على حساب الحكومة المدنية، مما يعمق انقسامات السلطة ويضعف المؤسسات الحكومية.
التأثير على المجتمع المدني ونسيج الحكم المحلي
نتيجة للدعم الإماراتي والروسي لقوات الدعم السريع، تُعزز الجماعات المسلحة سيطرتها على مناطق عديدة في السودان، خاصة المناطق الغنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب. وهذا يؤدي إلى تدهور سلطة الحكومة المركزية في هذه المناطق وخلق فراغ في الحكم المحلي، حيث تكون السلطة بيد قوات الدعم السريع والقبائل المحلية الحليفة لها. ويؤدي هذا إلى تقويض الجهود الرامية لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية المحلية، ويعزز من قبضة الجماعات المسلحة على المجتمع المحلي.

خسائر الأرواح والتشرد الجماعي
مع تزايد حدة الصراع المستمر منذ أبريل 2023، شهد السودان تصاعدًا كبيرًا في الخسائر البشرية وحالات التهجير القسري. وفقًا لأحدث التقارير، تجاوز عدد القتلى المدنيين منذ اندلاع القتال في الخرطوم والمناطق المحيطة بها الـ 7,500 شخص، بينما تقدر مصادر أخرى بأن الأعداد قد تكون أعلى نظرًا لعدم القدرة على الوصول إلى جميع مناطق النزاع لتوثيق الخسائر. (Sudan Tribune) - (UNOCHA).
فيما يخص النزوح، أشارت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (UNOCHA) إلى أن أكثر من 5.25 مليون شخص قد نزحوا نتيجة القتال، سواء داخل السودان أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة مثل تشاد، وجنوب السودان، مصر، وأثيوبيا. يعاني هؤلاء النازحون من ظروف إنسانية متدهورة، بما في ذلك نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى، لا سيما في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة.
الاقتصاد المعتمد على الموارد والآثار على المجتمعات المحلية
تسيطر قوات الدعم السريع، المدعومة من الإمارات، على مناطق غنية بالذهب والموارد الطبيعية، ما يمكنها من الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد عبر تصديرها للأسواق العالمية، وخاصة إلى الإمارات. ونتيجة لذلك، يتأثر السكان المحليون بشكل مباشر، حيث يتم تهجيرهم قسريًا بشكل مباشر أو غير مباشر من المناطق الغنية بالموارد، أو إجبارهم على العمل في ظروف قاسية لتشغيل المناجم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تدفق الأموال والأسلحة لقوات الدعم السريع أدى إلى تأجيج النزاعات المحلية والصراعات بين القبائل، خاصة في مناطق دارفور. تسعى قوات الدعم السريع إلى تعزيز نفوذها على هذه المناطق عبر تقديم دعم للزعماء المحليين، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات حول الأراضي والموارد، ويزيد من تقويض الاستقرار الاجتماعي.
الأثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع المدني
نتيجة للتوترات الداخلية والاضطرابات التي تعززها قوى خارجية، يواجه الاقتصاد السوداني أزمات متعددة تشمل تراجع قيمة العملة، ارتفاع معدلات التضخم، وتعطيل إنتاج وتصدير السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب. هذه العوامل تضع ضغوطًا إضافية على المجتمع السوداني المدني، الذي يجد نفسه عالقًا بين صراعات السلطة المسلحة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
تتسبب هذه الضغوطات الاقتصادية في زيادة التهميش الاجتماعي وانخفاض مستوى معيشة المواطنين السودانيين، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، بما في ذلك نقص الغذاء والخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة بين الشباب.
عرقلة المساعدات الإنسانية واستهداف المجتمع المدني

أدت العمليات العسكرية المكثفة والنزاعات المستمرة إلى تقييد قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية في مناطق النزاع. هناك قيود كبيرة على الوصول إلى المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة بسبب القتال أو سيطرة الميليشيات، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وتزايد معاناة السكان المتضررين.
إضافةً إلى ذلك، يتعرض المجتمع المدني في السودان للضغوط والقمع بسبب السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة مثل قوات الدعم السريع. تواجه المنظمات المحلية والصحفيون والناشطون تحديات متزايدة، بما في ذلك التهديدات بالعنف أو الاعتقال، مما يحد من قدرتهم على تقديم الدعم للمجتمعات المحلية أو الدعوة إلى حل النزاع بوسائل سلمية.
التأثير الاقتصادي طويل الأمد
التأثير على أسواق الذهب: سيطرة الإمارات ودورها في تشكيل السوق العالمية

كما أسلفنا، من خلال سيطرتها على تجارة الذهب في السودان وأجزاء أخرى من أفريقيا، تمكّنت الإمارات من لعب دورٍ رئيسيٍ في تشكيل أسواق الذهب العالمية. يعد السودان أحد كبار منتجي الذهب في أفريقيا، وتذهب نسبة كبيرة من هذا الذهب إلى الإمارات، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا في تجارة الذهب الأفريقية. بفضل هذه الشبكة الواسعة لتجارة الذهب، تعزز الإمارات من دورها في تحديد أسعار المعدن الأصفر وإدارته كسلعة أساسية على المستوى العالمي. بسبب التحالف مع قوات الدعم السريع التي تسيطر على مناطق تعدين الذهب، تعتبر الإمارات شريكًا أساسيًا في توجيه تدفق الذهب السوداني عبر قنواتها التجارية. وتتيح هذه العلاقة للإمارات فرض سيطرتها على جزء مهم من إمدادات الذهب غير الرسمية، حيث يُنقل الذهب من السودان ودول أفريقية أخرى عبر شبكات غير رسمية، ثم يتم إدخاله إلى السوق الإماراتية بشكلٍ شبه قانوني.
هذا التوجه الإماراتي له تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي للسودان، حيث يُهمش دور الدولة الرسمية في تنظيم عمليات التعدين وإدارة الإيرادات الناتجة عنها. كما أن سيطرة قوات الدعم السريع على موارد الذهب، وتوجيهه إلى قنوات التصدير غير الرسمية عبر الإمارات، يؤدي إلى فقدان الحكومة السودانية جزءًا كبيرًا من عائداتها، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة في السودان.
الدبلوماسية المالية والديون: تأثير الاستثمارات الإماراتية على الاقتصادات الأفريقية
من جانب آخر، تعتمد الإمارات على استراتيجيات الدبلوماسية المالية والديون لتعزيز نفوذها في الاقتصادات الأفريقية. من خلال الاستثمار المباشر في قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا، تقدم الإمارات دعمًا ماليًا كبيرًا لدول القارة، سواء عبر مؤسساتها الحكومية أو عبر مؤسسات تمويل تابعة للدولة مثل "ADQ".
ويؤدي هذا الدعم المالي إلى تعزيز نفوذ الإمارات الاقتصادي والسياسي في تلك الدول، حيث تصبح الحكومات المحلية معتمدة على القروض والاستثمارات الإماراتية في تطوير مشاريعها الكبرى. على الرغم من الفوائد الاقتصادية التي قد تحققها هذه الاستثمارات، إلا أنها قد تجعل الدول الأفريقية عالقة في "فخ الديون" التي قد تؤدي إلى تنازلها عن أجزاء من سيادتها على مواردها أو مناطق استراتيجية مثل الموانئ، كجزء من الديون غير المسددة أو كشرط للحصول على قروض جديدة.
على سبيل المثال، في سياق الزراعة والأمن الغذائي، يتم استثمار الأراضي الزراعية الأفريقية من قبل الإمارات بغرض تحقيق الأمن الغذائي للإمارات نفسها، وليس بالضرورة لتعزيز إنتاج الغذاء للمجتمعات المحلية في أفريقيا. بينما قد تحقق هذه الاستثمارات فوائد من خلال توفير البنية التحتية أو فرص العمل، إلا أنها قد تؤدي إلى تغيير في أولويات استخدام الأراضي، مما يؤثر على إنتاجية الزراعة المحلية والأمن الغذائي للمجتمعات الأفريقية.
الخاتمة: الصراع السوداني ومعركة النفوذ الإقليمي والدولي

إن الصراع الدائر في السودان يتجاوز كونه مجرد أزمة داخلية، بل هو انعكاس لتوازنات إقليمية معقدة وصراع قوى على النفوذ في المنطقة. وعلى الرغم من وجود جذور محلية للأزمة، إلا أن التدخلات الخارجية، وخاصة من قبل الإمارات، تعتبر جزءًا محوريًا في تفجير الوضع الحالي واستمراره. ساهم الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع بشكل مباشر في تعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية، مع بروز دور التجارة في الذهب كعنصر أساسي في تمويل الصراع وتحقيق المصالح الاقتصادية للإمارات على حساب استقرار السودان.
من ناحية أخرى، تجلى الطموح الإماراتي في السودان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تشمل القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، حيث تهدف الإمارات إلى تحقيق هيمنة سياسية واقتصادية وعسكرية. يتقاطع هذا الدور مع المصالح الروسية، خاصة عبر دعم قوات الدعم السريع وتسهيل وصول الذهب السوداني إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أهداف بناء نفوذ عسكري وتجاري مستدام.
بالمجمل، أدى هذا التدخل الخارجي إلى تأجيج النزاعات الداخلية وتفاقم الوضع الإنساني، مع ارتفاع معدلات التهجير، فقدان الأرواح، وزيادة معاناة المدنيين. يمثل الصراع السوداني نموذجًا حيًا لتداخل المصالح المحلية والإقليمية والدولية، حيث يؤدي الدعم الخارجي لتحقيق الأهداف الجيوسياسية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار وتعطيل عمليات التنمية والسلام. وبينما تستمر هذه التدخلات، يبقى السودان محاصرًا في دوامة من الصراع، مما يتطلب جهودًا إقليمية ودولية أكثر تكاملًا للتوصل إلى حلول تسهم في تحقيق السلام والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والاعتماد على المصالح الوطنية.
عليه، لا بد من دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الصراع السوداني، من خلال فرض رقابة على الأنشطة الاقتصادية والعسكرية التي تدعم الفصائل المسلحة، خاصة تجارة الذهب التي تستفيد منها قوات الدعم السريع. يتطلب هذا التحرك دعمًا من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لضمان تنفيذ العقوبات على الدول والشركات التي تساهم في تمويل الأطراف المسلحة أو تزويدها بالأسلحة والمعدات.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ المؤسسات الدولية خطوات جادة لتنسيق الجهود مع الجهات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة التدخلات الإماراتية والحد من تأثيرها السلبي على مستقبل السودان. يتضمن ذلك تشجيع عمليات تحقيق شفافة بشأن دعم الفصائل المسلحة، ومحاسبة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج الصراعات.
باختصار، إن معالجة الأوضاع في السودان تتطلب تحركًا دوليًا وإقليميًا متكاملًا لوقف التدخلات الأجنبية، خاصة من الإمارات، التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتعطيل التنمية والاستقرار. إن الضغط الدولي والمحاسبة الصارمة على التدخلات الخارجية يمكن أن يكون خطوة حاسمة نحو تمهيد الطريق لحل سياسي يضمن للسودان السيادة والاستقرار ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والتنمية.

